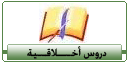كلام في الامتحان وحقيقته
كلام في الامتحان وحقيقته
لا ريب أن القرآن الكريم يخص أمر الهداية بالله سبحانه ، غير أن الهداية فيه لا تنحصر في الهداية الاختيارية إلى سعادة الآخرة أو الدنيا ، فقد قال تعالى فيما قال : ( الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ) طه : 50 .
فعمم الهداية لكل شيء من ذوى الشعور والعقل وغيرهم ، وأطلقها أيضاً من جهة الغاية .
وقال تعالى أيضاً : ( الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى * وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ) الأعلى : 2 – 3 ، والآية من جهة الإطلاق كسابقتها .
ومن هنا يظهر أن هذه الهداية غير الهداية الخاصة التي تقابل الإضلال ، فإن الله سبحانه نفاها وأثبت مكانها الضلال في طوائف ، والهداية العامة لا تنفي عن شيء من خلقه قال تعالى : ( وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ) الجمعة : 5 .
وقال : ( وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ) الصف : 5 ، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة .
وكذا يظهر أيضاً أن الهداية المذكورة غير الهداية بمعنى إراءة الطريق العامة للمؤمن والكافر كما في قوله تعالى : ( إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ) الإنسان : 3 .
وقوله : ( وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى ) فصلت : 17 .
فإن ما في هاتين الآيتين ونظائرهما من الهداية لا يعم غير أرباب الشعور والعقل ، وقد عرفت أن ما في قوله : ( ثُمَّ هَدَى ) ، وقوله : ( وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ) ، عام من حيث المورد والغاية جميعا ، على أن الآية الثانية تفرع الهداية على التقدير ، والهداية الخاصة لا تلائم التقدير الذي هو تهيئة الأسباب والعلل لسوق الشيء إلى غاية خلقته ، وإن كانت تلك الهداية أيضاً من جهة النظام العام في العالم داخلة في حيطة التقدير ، لكن النظر غير النظر فافهم ذلك .
وكيف كان فهذه الهداية العامة هي هدايته تعالى كل شيء إلى كمال وجوده ، وإيصاله إلى غاية خلقته ، وهي التي بها نزوع كل شيء إلى ما يقتضيه قوام ذاته من نشوء ، واستكمال ، وأفعال ، وحركات ، وغير ذلك ، وللكلام ذيل طويل سنشرحه إن ساعدنا التوفيق أن شاء الله العزيز .
والغرض أنَّ كلامه تعالى يدل على أن الأشياء إنما تنساق إلى غاياتها وآجالها بهداية عامة إلهية ، لا يشذُّ عنها شاذ ، وقد جعلها الله تعالى حقّاً لها على نفسه وهو لا يخلف الميعاد ، كما قال تعالى : ( إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى * وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى ) الليل : 12 – 13 .
والآية كما ترى تعمُّ بإطلاقها الهداية الاجتماعية للمجتمعات والهداية الفردية مضافة إلى ما تدل عليه الآيتان السابقتان .
فمن حق الأشياء على الله تعالى هدايتها تكويناً إلى كمالها المقدَّر لها ، وهدايتها إلى كمالها المشرع لها ، وقد عرفت فيما مر من مباحث النبوة أن التشريع كيف يدخل في التكوين ، وكيف يحيط به القضاء والقدر .
فإن النوع الإنساني له نوع وجود لا يتم أمره إلا بسلسلة من الأفعال الاختيارية الإرادية التي لا تقع إلا عن اعتقادات نظرية وعملية .
فلابد أن يعيش تحت قوانين حقة أو باطلة ، جيدة أو رديئة ، فلابدَّ لِسائق التكوين أن يهيئ له سلسلة من الأوامر والنواهي الشرعية ، وسلسلة أخرى من الحوادث الاجتماعية والفردية ، حتى يخرج بتلاقيه معهما ما في قوته إلى الفعل ، فيسعد أو يشقى ، ويظهر ما في مكمن وجوده ، وعند ذلك ينطبق على هذه الحوادث وهذا التشريع اسم المحنة والبلاء ونحوهما .
توضيح ذلك أن من لم يتبع الدعوة الإلهية واستوجب لنفسه الشقاء فقد حقَّت عليه كلمة العذاب إن بقى على تلك الحال .
فكل ما يستقبله من الحوادث المتعلقة بها الأوامر والنواهي الإلهية ، ويخرج بها من القوة إلى الفعل ، تتم له بذلك فعلية جديدة من الشقاء ، وإن كان راضياً بما عنده ، مغروراً بما يجده .
فليس ذلك إلا مكراً إلهيّاً ، فإنه يشقيهم بعين ما يحسبونه سعادة لأنفسهم ، ويخيب سعيهم في ما يظنُّونه فوزاًَ لأنفسهم .
قال تعالى : ( وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ) آل عمران : 54 .
وقال تعالى : ( وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ) فاطر : 43 .
وقال تعالى : ( لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ) الأنعام : 123 .
وقال تعالى : ( سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ * وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ) الأعراف : 183 .
فما يتبجح به المغرور الجاهل بأمر الله أنه سبق ربه في ما أراده منه بالمخالفة والتمرد ، فإنه يعينه على نفسه فيما أراده قال تعالى : ( أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاء مَا يَحْكُمُونَ ) العنكبوت : 4 .
ومن أعجب الآيات في هذا الباب قوله تعالى : ( فَلِلّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ) الرعد : 42 .
فجميع هذه المماكرات والمخالفات والمظالم والتعديات التي تظهر من هؤلاء بالنسبة إلى الوظائف الدينية وكل ما يستقبلهم من حوادث الأيام – ويظهر بها منهم ما أضمروه في قلوبهم ودعتهم إلى ذلك أهواؤهم – مكر إلهي وإملاء واستدراج .
فإن من حقِّهم على الله أن يهديهم إلى عاقبة أمرهم وخاتمته ، وقد فعل والله غالب على أمره .
وهذه الأمور بعينها إذا نسبت إلى الشيطان كانت أقسام الكفر والمعاصي إغواء منه لهم ، والنزوع إليها دعوة ، ووسوسة ، ونزعةً ، ووحياً ، وإضلالاً ، والحوادث الداعية وما يجرى مجراها زينة له ، ووسائل وحبائل وشبكات منه على ما سيجيء بيانه في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى .
وأما المؤمن الذي رسخ في قلبه الإيمان فما تظهر منه من الطاعات والعبادات وكذا الحوادث التي تستقبله ، فيظهر منه عندها ذلك ينطبق عليها مفهوم التوفيق والولاية الإلهية ، والهداية بالمعنى الأخص نوع انطباق .
قال تعالى : ( وَاللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاء ) آل عمران : 13 .
وقال تعالى : ( وَاللهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ) آل عمران : 68 .
وقال تعالى : ( اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ ) البقرة : 257 .
وقال تعالى : ( يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ ) يونس : 9 .
وقال تعالى : ( أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ ) الأنعام : 122 .
هذا إذا نسبت هذه الأمور إلى الله سبحانه ، وأما إذا نسبت إلى الملائكة فتسمَّى تأييداً وتسديداً منهم .
فقال تعالى : ( أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ) المجادلة : 22 .
ثم إنه كما أن الهداية العامة تصاحب الأشياء من بدء كونها إلى آخر أحيان وجودها ما دامت سالكة سبيل الرجوع إلى الله سبحانه كذلك المقادير تدفعها من ورائها كما هو ظاهر قوله تعالى : ( وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ) الأعلى : 3 .
فإن المقادير التي تحملها العلل والأسباب المحتفَّة بوجود الشيء هي التي تحول الشي من حال أولي إلى حال ثانية وَهَلُمَّ جَرّاً ، فهي لا تزال تدفع الأشياء من ورائها .
وكما أن المقادير تدفعها من ورائها كذلك الآجال ، وهي آخر ما ينتهي إليه وجود الأشياء تجذبها من أمامها ، كما يدل عليه قوله تعالى : ( مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ ) الأحقاف : 3 .
فإن الآية تربط الأشياء بغاياتها ، وهي الآجال ، والشيئان المرتبطان إذا قوى أحدهما على الآخر كان حاله بالنسبة إلى قرينه هو المسمى جذباً ، والآجال المسماة أمور ثابتة غير متغيرة ، فهي تجذب الأشياء من أمامها وهو ظاهر .
فالأشياء محاطة بقوى إلهية ، قوة تدفعها وقوة تجذبها ، وقوة تصاحبها وتربيها ، وهي القوى الأصلية التي تثبتها القرآن الكريم غير القوى الحافظة والرقباء والقرناء كالملائكة والشياطين وغير ذلك .
ثم إنا نسمي نوع التصرفات في الشيء إذا قصد به مقصد لا يظهر حاله بالنسبة إليه هل له صلوحه أو ليس له بالامتحان والاختبار ، فإنك إذا جهلت حال الشيء أنه هل يصلح لأمر كذا أو لا يصلح ، أو علمت باطن أمره ولكن أردت أن يظهر منه ذلك أوردت عليه أشياء مما يلائم المقصد المذكور ، حتى يظهر حاله بذلك ، هل يقبلها لنفسه أو يدفعها عن نفسه ، وتسمي ذلك امتحاناً واختباراً واستعلاماً لحاله أو ما يقاربها من الألفاظ .
وهذا المعنى بعينه ينطبق على التصرف الإلهي بما يورده من الشرائع والحوادث الجارية على أولي الشعور والعقل من الأشياء كالإنسان ، فإن هذه الأمور يظهر بها حال الإنسان بالنسبة إلى المقصد الذي يدعى إليه الإنسان بالدعوة الدينية ، فهي امتحانات إلهية .
وإنما الفرق بين الامتحان الإلهي وما عندنا من الامتحان أنا لا نخلو غالباً عن الجهل بما في باطن الأشياء ، فنريد بالامتحان استعلام حالها المجهول لنا ، والله سبحانه يمتنع عليه الجهل ، وعنده مفاتح الغيب .
فالتربية العامة الإلهية للإنسان من جهة دعوته إلى حسن العاقبة والسعادة امتحان ، لأنه يظهر ويتعين بها حال الشيء أنه من أهل أي الدارين ؟ ، دار الثواب أو دار العقاب ؟ .
ولذلك سمى الله تعالى هذا التصرف الإلهي من نفسه أعنى التشريع وتوجيه الحوادث بلاءً وابتلاءً وفتنة ، فقال تعالى بوجه عام : ( إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ) الكهف : 7 .
وقال تعالى : ( إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ) الإنسان : 2 ، وقال : ( وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ) الأنبياء : 35 .
وكأنه يريد به ما يفصله قوله : ( فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ * وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ) الفجر : 15 – 16 .
وقال تعالى : ( إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ) التغابن : 15 .
وقال تعالى : ( وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ) محمد : 4 .
وقال تعالى : ( كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ) الأعراف : 163 .
وقال تعالى : ( وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاء حَسَناً ) الأنفال : 17 .
وقال تعالى : ( أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ) العنكبوت : 2 – 3 .
وقال تعالى في مثل إبراهيم : ( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ) البقرة : 124 .
وقال تعالى في قصة ذبح إسماعيل : ( إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاء الْمُبِينُ ) الصافات : 106 .
وقال تعالى في موسى : ( وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ) طه : 40 ، إلى غير ذلك من الآيات .
والآيات كما ترى تعمم المحنة والبلاء لجميع ما يرتبط به الإنسان من وجوده وأجزاء وجوده ، كالسمع والبصر والحياة ، والخارج من وجوده المرتبط به بنحو ، كالأولاد والأزواج ، والعشيرة والأصدقاء ، والمال والجاه ، وجميع ما ينتفع به نوع انتفاع .
وكذا مقابلات هذه الأمور ، كالموت ، وسائر المصائب المتوجهة إليه ، وبالجملة الآيات تعد كل ما يرتبط به الإنسان من أجزاء العالم وأحوالها فتنة وبلاءً من الله سبحانه بالنسبة إليه .
وفيها تعميم آخر من حيث الإفراد ، فالكل مفتنون مبتلون من مؤمن أو كافر ، وصالح أو طالح ، ونبي أو من دونه ، فهي سُنَّة جارية لا يُستثنى منها أحد .
فقد بَان أن سُنَّة الامتحان سُنَّة إلهية جارية ، وهي سُنَّة عملية متكئة على سُنَّة أخرى تكوينية ، وهي سُنَّة الهداية العامة الإلهية من حيث تعلقها بالمكلفين ، كالإنسان وما يتقدمها وما يتأخر عنها ، أي القدر والأجل كما مرَّ بيانه .
ومن هنا يظهر أنها غير قابلة للنسخ ، فإن انتساخها عين فساد التكوين ، وهو محال ويشير إلى ذلك ما يدل من الآيات على كون الخلقة على الحق وما يدل على كون البعث حقا كقوله تعالى : ( مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ) الأحقاف : 3 .
وقوله تعالى : ( أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ) المؤمنون : 115 .
وقوله تعالى : ( وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ * مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ) الدخان : 38 – 39 .
وقوله تعالى : ( مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآتٍ ) العنكبوت : 5 ، إلى غيرها .
فإن جميعها تدل على أن الخلقة بالحق وليست باطلة مقطوعة عن الغاية ، وإذا كانت أمام الأشياء غايات وآجال حقة ، ومن ورائها مقادير حقة ، ومعها هداية حقة ، فلا مناص عن تصادمها عامة ، وابتلاء أرباب التكليف منها .
خاصة بأمور يخرج بالاتصال بها ما في قوتها من الكمال والنقص والسعادة والشقاء إلى الفعل ، وهذا المعنى في الإنسان المكلف بتكليف الدين امتحان وابتلاء فافهم ذلك .
ويظهر مما ذكرناه معنى المحق والتمحيص أيضاً ، فإن الامتحان إذا ورد على المؤمن فأوجب امتياز فضائله الكامنة من الرذائل أو ورد على الجماعة فاقتضى امتياز المؤمنين من المنافقين والذين في قلوبهم مرض صدق عليه اسم التمحيص ، وهو التمييز .
وكذا إذا توالت الامتحانات الإلهية على الكافر والمنافق وفي ظاهرهما صفات وأحوال حسنة مغبوطة ، فأوجبت تدريجاً ظهور ما في باطنهما من الخبائث ، وكلما ظهرت خبيثة أزالت فضيلة ظاهرية كان ذلك مَحقاً له ، أي إنفادا تدريجياً لمحاسنها .
فقال تعالى : ( إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ * وَلِيُمَحِّصَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ) آل عمران : 140 – 141 .
وللكافرين محق آخر من جهة ما يخبره تعالى أن الكون ينساق إلى صلاح البشر وخلوص الدين لله ، فقال تعالى : ( وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ) طه : 132 .
وقال تعالى : ( أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ) الأنبياء : 105 .
وقال تعالى : ( وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ) آل عمران : 144 ، الموت زهاق الروح وبطلان حياة البدن ، والقتل هو الموت إذاً كان مستندا إلى سبب عمدي أو نحوه ، والموت والقتل إذا افترقا كان الموت أعم من القتل ، وإذا اجتمعا كان الموت هو ما بحتف الأنف والقتل خلافه .
وانقلب على عقبيه أي : رجع ، قال الراغب : ورجع على عقبيه إذا انثنى راجعاً وانقلب على عقبيه ، نحو : رجع على حافرته ، ونحو : ارتدّا على آثارهما قصصاً ، وقولهم : رجع عوده إلى بدئه .
وحيث جعل الانقلاب على الأعقاب جزاءً للشرط الذي هو موت الرسول ( صلى الله عليه وآله ) أو قتله أفاد ذلك أن المراد به الرجوع عن الدين دون التولي عن القتال .
إذ لا ارتباط للفرار من الزحف بموت النبي ( صلى الله عليه وآله ) أو قتله ، وإنما النسبة والرابطة بين موته أو قتله وبين الرجوع إلى الكفر بعد الإيمان .
ويدل على أن المراد به الرجوع عن الدين ما ذكره تعالى في قوله : ( وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ) آل عمران : 154 ، إلى آخر الآيات .
على أن نظير ما وقع في أحد من فرارهم من الزحف وتولِّيهم عن القتال تحقق في غيره ، كغزوة حنين وخيبر وغيرهما ، ولم يخاطبهم الله بمثل هذا الخطاب ولا عبر عن تولِّيهم عن القتال بمثل هذه الكلمة .
فقال تعالى : ( وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ) التوبة : 25 ، فالحق أنَّ المراد بالانقلاب على الأعقاب الرجوع إلى الكفر السابق .
فمحصل معنى الآية على ما فيها من سياق العتاب والتوبيخ أن محمداً ( صلى الله عليه وآله ) ليس إلاَّ رسولاً من الله مثل سائر الرسل ، ليس شأنه إلا تبليغ رسالة ربه ، لا يملك من الأمر شيئاً ، وإنما الأمر لله ، والدين دينه باقٍ ببقائه ، فما معنى اتكاء إيمانكم على حياته ، حيث يظهر منكم أن لو مات أو قتل تركتم القيام بالدين ورجعتم إلى أعقابكم القهقرى واتخذتم الغواية بعد الهداية ؟ .
وهذا السياق أقوى شاهد على أنهم ظنوا يوم أُحُد بعد حمى الوطيس أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد قتل ، فانسلوا عند ذلك وتولوا عن القتال .
فيتأيد بذلك ما ورد في الرواية والتاريخ كما في ما رواه ابن هشام في السيرة : أن أنس بن النضر عم أنس بن مالك انتهى إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار ، وقد ألقوا بأيديهم .
فقال : ما يحبسكم ؟ ، قالوا : قتل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
فقال : فماذا تصنعون بالحياة بعده ؟ ، فموتوا على ما مات عليه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم استقبل القوم ، فقاتل حتى قُتل .
وبالجملة فمعنى هذا الانسلال والإلقاء بالأيدي أنَّ إيمانهم إنما كان قائماً بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) يبقى ببقائه ويزول بموته ، وهو إرادة ثواب الدنيا بالإيمان ، وهذا هو الذي عاتبهم الله عليه .
ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى بعده : ( وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ ) آل عمران : 144 .
فإن الله سبحانه كرر هذه الجملة في الآية التالية بعد قوله تعالى : ( وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ) آل عمران : 145 ، فافهم ذلك .
وقوله : ( وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ ) بمنزلة الاستثناء مما قبله على ما يعطيه السياق ، وهو الدليل على أن القوم كان فيهم من لم يظهر منه هذا الانقلاب أو ما يشعر به كالانسلال والتولي وهم الشاكرون .
وحقيقة الشكر إظهار النعمة ، كما أن الكفر الذي يقابله هو إخفاؤها والستر عليها ، وإظهار النعمة هو استعمالها في محلها الذي أراده منعمها ، وذكر المنعم بها لساناً ، وهو الثناء ، وقلبا من غير نسيان .
فشكره تعالى على نعمة من نعمه أن يذكر عند استعمالها ويوضع النعمة في الموضع الذي أراده منها ولا يتعدَّى ذلك وإن من شيء إلا وهو نعمة من نعمه تعالى ولا يريد بنعمة من نعمه ، إلا أن تستعمل في سبيل عبادته فقال تعالى : ( وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ) إبراهيم : 34 ، فشكره على نعمته أن يُطاع فيها ، ويذكر مقام ربوبيته عندها .
وعلى هذا فشكره المطلق من غير تقييد ذكره تعالى من غير نسيان وإطاعته من غير معصية ، فمعنى قوله : ( وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ ) البقرة : 152 .
اذكروني ذكراً لا يخالطه نسيان ، وأطيعوا أمري إطاعة لا يشوبها عصيان ، ولا يصغي إلى قول من يقول إنه أمر بما لا يطاق ، فإنه ناشٍ من قلة التدبر في هذه الحقائق والبعد من ساحة العبودية .
وقد عرفت فيما تقدم من الكتاب أن إطلاق الفعل لا يدل إلا على تلبس ما بخلاف الوصف ، فإنه يدل على استقرار التلبس وصيرورة المعنى الوصفي مَلَكة لا تفارق الإنسان .
ففرِّق بين قولنا : الذين أشركوا ، والذين صبروا ، والذين ظلموا ، والذين يعتدون ، وبين قولنا : المشركين ، والصابرين ، والظالمين ، والمعتدين ، فالشاكرون هم : الذين ثبت فيهم وصف الشكر واستقرَّت فيهم هذه الفضيلة ، وقد بان أنَّ الشكر المطلق هو أن لا يذكر العبد شيئاً – وهو نعمة – إلا وذكر الله معه ، ولا يمسُّ شيئاً وهو نعمة إلا ويطيع الله فيه .
فقد تبين أن الشكر لا يتم إلا مع الإخلاص لله سبحانه علماً وعملاً ، فالشاكرون هم المخلصون لله الذين لا مَطمع للشيطان فيهم .
ويظهر هذه الحقيقة ممَّا حكاه الله تعالى عن إبليس ، فقال تعالى : ( قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ) ص : 83 .
وقال تعالى : ( قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ) الحجر : 39 – 40 .
فلم يستثنِ من إغوائه أحداً إلا المخلصين ، وأمضاه الله سبحانه من غير رد ، وقال تعالى : ( قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ * ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ) الأعراف : 17 .
وقوله تعالى : ( وَلاَ تَجِدُ ) إلخ بمنزلة الاستثناء ، فقد بدل المخلصين بالشاكرين ، وليس إلا لأن الشاكرين هم المخلصون الذين لا مطمع للشيطان فيهم ولا صنع له لديهم ، وإنما صنعه وكيده إنساء مقام الربوبية ، والدعوة إلى المعصية .
ومما يؤيد ذلك من هذه الآيات النازلة في غزوة أحد قوله تعالى فيما سيأتي من الآيات : ( إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا اللّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ) آل عمران : 155 ، مع قوله في هذه الآية التي نحن فيها : ( وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ ) ، وقوله فيما بعدها : ( وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ) ، وقد عرفت أنَّه في معنى الاستثناء .
فتدبر فيها واقضِ عجباً ممَّا ربما يقال : إن الآية أعني قوله : إن الذين تولوا منكم ناظرة ، إلى ما روي : أن الشيطان نادى يوم أحد : ألا قد قتل محمد ، فأوجب ذلك وهن المؤمنين وتفرقهم عن المعركة ، فاعتبر إلى أي مهبط اهبط كتاب الله من أوج حقائقه ومستوى معارفه العالية ؟ .
فالآية تدل على وجود عدَّة منهم يوم أحد لم ينهوا ولم يفتروا ولم يفرطوا في جنب الله سبحانه سمَّاهم الله ( شاكرين ) ، وصدق أنهم لا سبيل للشيطان إليهم ، ولا مطمع له فيهم لا في هذه الغزوة فحسب ، بل هو وصف لهم ثابت فيهم مستقر معهم .
ولم يطلق اسم الشاكرين في مورد من القرآن على أحد بعنوان على طريق التوصيف إلا في هاتين الآيتين ، أعني قوله تعالى : ( وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ ) آل عمران : 144 .
وقوله تعالى : ( وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ الله ) آل عمران : 145 ، ولم يذكر ما يجازيهم به في شيء من الموردين إشعاراً بعظمته ونفاسته .
وقوله تعالى : ( وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ الله كِتَاباً مُّؤَّجَّلاً ) آل عمران : 145 ، تعريض لهم في قولهم عن إخوانهم المقتولين ما يشير إليه قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزًّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ ) آل عمران : 156 .
وقول طائفة منهم : ( لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا ) آل عمران : 154 . .
وهؤلاء من المؤمنين غير المنافقين ، الذين تركوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقعدوا عن القتال .
فهذا القول منهم لازمه أن لا يكون موت النفوس بإذن من الله وسُنَّة محكمة تصدر عن قضاء مبرم ، ولازمه بطلان الملك الإلهي والتدبير المتقن الرباني ، وسيجيء إن شاء الله الكلام في معنى كتابة الآجال في أول سورة الأنعام .
ولما كان لازم هذا القول ممن قال به أنه آمن لظنِّه أن الأمر لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وللمؤمنين ، فقد أراد الدنيا كما مَرَّ بيانه ، ومن اجتنب هذا فقد أراد الآخرة .
فقال تعالى : ( وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ) آل عمران : 145 ، وإنما قال : ( نُؤْتِهِ مِنْهَا ) ولم يقل : نؤتِها ، لأن الإرادة ربما لا توافق تمام الأسباب المؤدية إلى تمام مراده ، فلا يرزق تمام ما أراده .
ولكنها لا تخلو من موافقة ما للأسباب في الجملة دائماً ، فإن وافق الجميع رزق الجميع ، وإن وافق البعض رزق البعض فحسب .
فقال الله تعالى : ( مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاء لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا * وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا ) الإسراء 18 – 19 .
وقال تعالى : ( وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ) النجم : 39 .
ثم خصَّ الشاكرين بالذكر بإخراجهم من الطائفتين ، فقال : ( وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ) ، وليس إلا لأنهم لا يريدون إلا وجه الله ، لا يشتغلون بدنيا ولا آخرة كما تقدم .
وقوله تعالى : ( وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ ) آل عمران : 146 ، إلى آخر الآيات .
( كَأَيِّن ) كلمة تكثير ، وكلمة ( مِّن ) بيانية ، والـ( رِبِّيُّونَ ) جمع ربي ، وهو كـ( الرباني ) ، من اختص بربه تعالى فلم يشتغل بغيره ، وقيل المراد به الألوف ، والربي الألف ، والاستكانة هي التضرع .
وفي الآية موعظة واعتبار مشوب بعتاب وتشويق للمؤمنين أن يأتمّوا بهؤلاء الربيين ، فيؤتيهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة كما آتاهم ، ويحبهم لإحسانهم كما أحبهم لذلك .
وقد حكى الله من فعلهم وقولهم ما للمؤمنين أن يعتبروا به ويجعلوه شعاراً لهم ، حتى لا يبتلوا بما ابتلوا به يوم أُحُد من الفعل والقول غير المرضيين لله تعالى ، وحتى يجمع الله لهم ثواب الدنيا والآخرة كما جمع لأولئك الربيين .
وقد وصف ثواب الآخرة بالحسن دون الدنيا ، إشارة إلى ارتفاع منزلتها وقدرها بالنسبة إليها .
المصدر: تفسير الميزان 4/31.
![]()