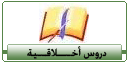كلام في الإيمان وازدياده
كلام في الإيمان وازدياده
الإيمان بالشيء ليس مجرد العلم الحاصل به كما يستفاد من أمثال قوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ) محمد : 25 .
وقوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الهُدَى ) محمد : 32 .
وقوله تعالى : ( وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ) النمل : 14 .
وقوله تعالى : ( وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ ) الجاثية : 23 .
فالآيات – كما ترى – تثبت الارتداد والكفر والجحود والضلال مع العلم .
فمجرد العلم بالشيء والجزم بكونه حقّاً لا يكفي في حصول الإيمان واتِّصاف من حصل له به ، بل لابد من الالتزام بمقتضاه ، وعقد القلب على مؤدَّاه بحيث يترتَّب عليه آثاره العملية ، ولو في الجملة .
فالذي حصل له العلم بأنَّ الله تعالى إله لا إله غيره ، فالتزم بمقتضاه وهو عبوديته وعبادته وحده كان مؤمناً ، ولو علم به ولم يلتزم فلم يأتِ بشيء من الأعمال المظهرة للعبودية كان عالماً وليس بمؤمن .
ومن هنا يظهر بطلان ما قيل : إن الإيمان هو مجرد العلم والتصديق ، وذلك لما مَرَّ أنَّ العلم ربما يجامع الكفر .
ويظهر أيضا بطلان ما قيل : إن الإيمان هو العمل ، وذلك لأن العمل يجامع النفاق ، فالمنافق له عمل ، وربما كان ممَّن ظهر له الحق ظهورا علمياً ولا إيمان له على أي حال .
وإذ كان الإيمان هو العلم بالشيء مع الالتزام به بحيث يترتب عليه آثاره العملية ، وكل من العلم والالتزام مما يزداد وينقص ويشتد ويضعف كان الإيمان المؤلف منهما قابلاً للزيادة والنقيصة ، والشدة والضعف ، فاختلاف المراتب وتفاوت الدرجات من الضروريات التي لا يُشَك فيها قط .
هذا ما ذهب إليه الأكثر – وهو الحق – ، ويدل عليه من النقل قوله تعالى : ( لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ ) الفتح : 4 ، وغيره من الآيات .
وما ورد من أحاديث أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) الدالة على أن الإيمان ذو مراتب .
وذهب جمع – منهم أبو حنيفة وإمام الحرمين وغيرهما – إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ، واحتجوا عليه بأن الإيمان اسم للتصديق البالغ حدّ الجزم والقطع ، وهو مما لا يتصور فيه الزيادة والنقصان ، فالمصدق إذا ضمَّ إلى تصديقه الطاعات أو ضَمَّ إليه المعاصي فتصديقه بحاله لم يتغيَّر أصلاً .
وأولوا ما دَلَّ من الآيات على قبوله الزيادة والنقصان بأن الإيمان عرض لا يبقى بشخصه بل بتجدَّد الأمثال .
فهو بحسب انطباقه على الزمان بأمثاله المتجددة يزيد وينقص ، كوقوعه للنبي ( صلى الله عليه وآله ) مثلاً على التوالي من غير فترة متخلِّلة ، وفي غيره بفترات قليلة أو كثيرة .
فالمراد بزيادة الإيمان توالي أجزاء الإيمان من غير فتره أصلاً أو بفترات قليلة .
وأيضا للإيمان كثرة بكثرة ما يؤمن به ، وشرائع الدين لما كانت تنزل تدريجاً والمؤمنون يؤمنون بما ينزل منها ، وكان يزيد عدد الأحكام حيناً بعد حين كان إيمانهم أيضا يزيد تدريجاً ، وبالجملة المراد بزيادة الإيمان كثرته عدداً ، وهو بيِّن الضعف .
أما الحجة ففيها أولاً : أن قولهم : الإيمان اسم للتصديق الجازم ، ممنوع ، بل هو اسم للتصديق الجازم الذي معه الالتزام ، كما تقدَّم بيانه ، اللهم إلا أن يكون مرادهم بالتصديق العلم مع الالتزام .
وثانيا : أن قولهم : أن هذا التصديق لا يختلف بالزيادة والنقصان دعوى بلا دليل ، بل مصادرة على المطلوب ، وبناؤه على كون الإيمان عرضاً ، وبقاء الأعراض على نحو تجدد الأمثال لا ينفعهم شيئاً .
فإن من الإيمان ما لا تحركه العواصف ، ومنه ما يزول بأدنى سبب يعترض وأوهن شبهة تطرأ ، وهذا مما لا يعلل بتجدد الأمثال وقلَّة الفترات وكثرتها ، بل لابُدَّ من استناده إلى قوة الإيمان وضعفه ، سواء قلنا بتجدد الأمثال أم لا ، مضافاً إلى بطلان تجدد الأمثال على ما بُيِّن في محله .
وقولهم : إن المصدق إذا ضمَّ إليه الطاعات أو ضم إليه المعاصي لم يتغير حاله أصلاً ممنوع ، فقوة الإيمان بمزاولة الطاعات وضعفها بارتكاب المعاصي ، مما لا ينبغي الارتياب فيه .
وقوة الأثر وضعفه كاشفة عن قوة مبدأ الأثر وضعفه ، فقال تعالى : ( إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ) فاطر : 10 .
وقال تعالى : ( ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا السُّوأَى أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِؤُون ) الروم : 10 .
وأما ما ذكروه من التأويل فأول التأويلين يوجب كون من لم يستكمل الإيمان ، وهو الذي في قلبه فترات خالية من أجزاء الإيمان على ما ذكروه مؤمناً وكافراً حقيقة ، وهذا مما لا يساعده ولا يشعر به شيء من كلامه تعالى : ( وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ ) يوسف : 106 .
فهو إلى الدلالة على كون الإيمان ممَّا يزيد وينقص أقرب منه إلى الدلالة على نفيه ، فإن مدلوله أنهم مؤمنون في حال أنهم مشركون فإيمانهم إيمان بالنسبة إلى الشرك المحض وشرك بالنسبة إلى الإيمان المحض ، وهذا معنى قبول الإيمان للزيادة والنقصان .
وثاني التأويلين يفيد أن الزيادة في الإيمان وكثرته إنما هي بكثرة ما تعلق به ، وهو الأحكام والشرائع المنزَّلة من عند الله ، فهي صفة للإيمان بحال متعلقه ، والسبب في اتِّصافه بها هو متعلقه .
ولو كان هذه الزيادة هي المرادة من قوله : ( لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ ) الفتح : 4 ، كان الأنسب أن تجعل زيادة الإيمان في الآية غاية لتشريع الأحكام الكثيرة وإنزالها لا لإنزال السكينة في قلوب المؤمنين .
هذا وحمل بعضهم زيادة الإيمان في الآية على زيادة أثره وهو النور المشرق منه على القلب ، وفيه : أن زيادة الأثر وقوَّته فرع زيادة المؤثر وقوَّته ، فلا معنى لاختصاص أحد الأمرين المتساويين من جميع الجهات بأثر يزيد على أثر الآخر .
وذكر بعضهم أن الإيمان الذي هو مدخول مع في قوله تعالى : ( لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ ) الفتح : 4 ، الإيمان الفطري ، والإيمان المذكور قبله هو الإيمان الاستدلالي ، والمعنى : ليزدادوا إيماناً استدلالياً على إيمانهم الفطري .
وفيه أنه دعوى من غير دليل يدل عليه ، على أن الإيمان الفطري أيضاً استدلالي ، فمتعلَّق العلم والإيمان على أي حالٍ أمر نظري لا بديهي .
وقال بعضهم كالإمام الرازي : إن النزاع في قبول الإيمان للزيادة والنقص وعدم قبوله نزاع لفظي ، فمراد النافين عدم قبول أصل الإيمان ، وهو التصديق ذلك وهو كذلك لعدم قبوله الزيادة والنقصان .
ومراد المثبتين قبول ما به كمال الإيمان وهو الأعمال للزيادة والنقصان وهو كذلك بلا شك .
وفيه : أولاً : أن فيه خلطاً بين التصديق والإيمان ، فالإيمان تصديق مع الالتزام وليس مجرد التصديق فقط كما تقدم بيانه .
ثانياً : أن نسبة نفي الزيادة في أصل الإيمان إلى المثبتين غير صحيحة ، فهم إنما يثبتون الزيادة في أصل الإيمان ، ويرون أن كُلاًّ من العلم والالتزام المؤلف منهما الإيمان يقبل القوة والضعف .
ثالثاً : أن إدخال الأعمال في محلِّ النزاع غير صحيح ، لأن النزاع في شيء غير النزاع في أثره الذي به كماله ، ولا نزاع لأحد في أن الأعمال والطاعات تقبل العد ، وتقل وتكثر بحسب تكرر الواحد .
المصدر: تفسير الميزان 18/259.
المصدر
![]()